
الأمة الأزمة والمخرج
- بواسطة مؤتمر الأمة --
- الخميس 15 جمادى الثانية 1434 03:21 --
- 0 تعليقات
بقلم د. حاكم المطيري
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وآله وصحبه أجمعين وبعد :
إطلالة تاريخية :
لم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى نزل قوله تعالى {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} وحتى قال صلى الله عليه وسلم (تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك)، وقال (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي).
فحدد صلى الله عليه وسلم طبيعة النظام بعده وأنه نظام خلافة تقوم على الشورى والرضا، وحق الأمة في اختيار السلطة، وتعبر عن وحدة الأمة والدولة، وذلك في آحاديث متواترة تواترا معنويا فقال صلى الله عليه وسلم (من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار)، كما قال أيضا(تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم يكون ملكا عضوضا ثم ملكا جبريا ثم تعود خلافة على منهاج النبوة)، وكما في قوله في الحديث الصحيح (يكون خلفاء فيكثرون فأوفوا بيعة الأول فالأول)، وقال (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما) ...الخ.
فأجمع الصحابة على ذلك كله وأن الأمر بعد النبوة خلافة لها أصولها وقواعدها، وأحكامها ومقاصدها، وقد عبرت الخلافة كنظام سياسي عن طبيعة الدولة الإسلامية وهوية الأمة الإسلامية على مر العصور، ومع ما طرأ عليها من تراجعات وتطورات إلا إنها ظلت الجامعة لوحدة الأمة، الحامية لوجودها المادي والمعنوي، السياسي والأيديولوجي، والحافظة لهويتها وخصوصيتها، وهو ما جعل الغرب الصليبي يجعل من أولى أولوياته القضاء على الخلافة كنظام سياسي، حيث بدأ التخطيط لذلك منذ معاهدة كارلوفوجه سنة 1699م كما ذكره المؤرخ الفرنسي غروسيه في كتابه (وجه آسيا)، ثم في مؤتمر برلين سنة 1880 م، وتوج ذلك بإسقاطها بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1924م، وقد ضج العالم الإسلامي آنذاك من أقصاه إلى أقصاه، وأدرك علماء الأمة مدى خطورة سقوطها، وأنه لا بقاء للإسلام بسقوط الخلافة، كما عبر عن ذلك آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية الشيخ مصطفى صبري، والشيخ محمد رشيد رضا، فلم يكن سقوط الخلافة بعد الحرب العالمية الأولى على يد الحملة الصليبية الثامنة على العالم الإسلامي حدثا سياسيا عابرا فقط ـ كما يتصوره البعض ـ بحيث يمكن معالجة إشكالاته بحلول سياسية مؤقتة، بل كان حدثا مفصليا في تاريخ العالم الإسلامي ما زالت الأمة كلها تعيش تداعياته إلى يومنا هذا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وروحيا حيث تعيش الأمة أزمة هوية كبرى عبر عنها كثير من المفكرين والمؤرخين الغربيين أنفسهم كما تنبه له فرومكين في كتابه(ولادة الشرق)حيث يقول:
(أصبح الشرق الأوسط على ما هو عليه الآن، لأن الدول الأوربية أخذت على عاتقها أن تعيد تشكيله من جهة، ولأن بريطانيا وفرنسا أخفقتا في ضمان استمرار الأسر الحاكمة، والدول، والنظم السياسية، التي أوجدتاها، بعد أن قضتا خلال الحرب العالمية الأولى قضاء مبرما على النظام القديم في المنطقة – أي الخلافة - وحطمتا الحكم العثماني للشرق الأوسط العربي تحطيما لا خلاص منه، ولكي تأخذ الدولتان مكان النظام القديم، أوجدتا بلدانا، وعينتا حكاما، ورسمتا حدودا، وأدخلتا نظام دول، ولكنهما لم تقضيا على كل معارضة محلية هامة لقراراتهما، ولا تزال إلى يومنا هذا قوى محلية ذات بأس في الشرق الأوسط غير موافقة على هذه الترتيبات، وقد تطيح بها، إن ثمة مطالب هي أكثر صلة بالجوهر، وهذه الخلافات لا تقتصر على الحدود فحسب، بل تطرح أيضا حق الوجود لبلدان انبثقت عن القرارات البريطانية الفرنسية في أوائل العشرينات من القرن العشرين، وهذه الخلافات تذهب إلى غور أعمق، وتبحث مسائل تبدو مستعصية على الحل وهي: هل يستطيع النظام الحديث الذي ابتكرته أوربا ونقلته إلى المنطقة، ومن مميزاته تقسيم الأرض إلى دول علمانية مستقلة أساسها مواطنية قومية أن يكون هو البديل؟
إن الأفكار السياسية الأوربية ومنها الحكومة المدنية العلمانية، تعد عقيدة غريبة على منطقة أكد معظم سكانها، ولمدة تربو على ألف عام، إيمانهم بشريعة دينية تحكم كل جوانب الحياة، ومنها الحكومة والسياسة، لقد أقر فعلا رجال الدولة الأوربيون في زمن الحرب العالمية الأولى بوجود المشكلة وبأهميتها، فما إن بدأ قادة الحلفاء يخططون لضم الشرق الأوسط إلى دولهم، حتى أدركوا أن سلطة الإسلام على المنطقة هي الخاصية الرئيسية للخريطة السياسية، التي يتحتم عليهم أن يجابهوها، وقد شن كيتنشر عام 1914م سياسة هدفها جعل الإسلام تحت سيطرة بريطانيا، فلما ظهر أن هذه السياسة لن تنجح، رأى معاونو كيتنشر البديل في رعاية ولاءات أخرى، لاتحاد شعوب عربية، أو لأسرة الشريف حسين، أو لبلدان كان عليها أن تخرج للوجود كالعراق، وأن تكون هذه الولاءات منافسة للوحدة الإسلامية، والحقيقة أنهم عندما صاغوا تسوية الشرق الأوسط لما بعد الحرب، كان هذا الهدف نصب أعينهم، بيد أن فهم المسئولين الأوربيين في ذلك الحين للإسلام كان ضئيلا، فقد هونوا الأمور باقتناعهم أن المعارضة الإسلامية للعصرنة لإضفاء الصبغة الأوربية كانت في طريقها للتلاشي، ولو أبصروا النصف الثاني من القرن العشرين لأدهشتهم حمية المذهب الوهابي في المملكة العربية السعودية، وعاطفة الإيمان الديني في أفغانستان المتحاربة، واستمرار حيوية الأخوان المسلمين في مصر وسوريا، وغيرهما من العالم السني، والثورة الخمينية في إيران الشيعية، إن استمرارية المقاومة المحلية لتسوية عام 1922م، وللأفكار الأساسية التي قامت على أساسها، تفسر أنه لا وجود في الشرق الأوسط للإحساس بالشرعية، وليس في المنطقة إيمان يشارك فيه الجميع بأن الكيانات التي تسمي نفسها بلدانا، والرجال الذين يدعون أنهم حكاما، لها أو لهم حق الاعتراف بهم كبلدان أو كحكام، ولا يمكن القول بأن الذين خلفوا السلاطين العثمانيين، قد نصبوا في مناصبهم بصفة دائمة، مع أن هذا ما اعتقد الحلفاء أنهم فاعلوه بين عامي 1919 و1922م.)[1].
ويقول فرومكين أيضا:( إذا استمر زخم التحديات، لتسوية 1922م أي لوجود الأردن، وإسرائيل، والعراق، ولبنان، على سبيل المثال، فإننا سنرى يوما ما الشرق الأوسط الذي عرفناه في القرن العشرين في وضع يشبه وضع أوربا في القرن الخامس الميلادي، عندما ألقى انهيار الإمبراطورية الرومانية في الغرب، شعوب الإمبراطورية في خضم أزمة حضارة، لقد احتاجت أوربا إلى ألف وخمسمائة عام لتحل أزمة هويتها الاجتماعية والسياسية بعد زوال الإمبراطورية الرومانية، منها نحو ألف سنة لكي يستقر النظام السياسي على شكل الدولة الأمة، ونحو خمسمائة سنة أخرى لتقرير من هي الأمم التي تملك الحق في أن تشكل دولا، وهل يكون الولاء للسلالات الأسرية، أو للدولة القومية، أو لدول المدن؟ لقد تبين أن موضوع أزمة الشرق الأوسط المستمرة في زمننا، هو مثيل موضوع أزمة أوربا الغربية، وإن لم يكن بنفس العمق وطول الزمن، فكيف تستطيع شعوب متنوعة أن تعيد تجميع نفسها لخلق هويات سياسية جديدة، بعد انهيار نظام إمبراطوري طويل العهد اعتادت عليه؟ لقد اقترحت دول الحلفاء في مطلع العشرينيات من القرن العشرين شكلا للمنطقة بعد زوال الدولة العثمانية، لكن السؤال الذي لا يزال قائما:هل تقبله شعوب المنطقة؟ ولذلك فإن تسوية 1922م لا تخص الماضي، بل هي في قلب الحروب والنزاعات والسياسات الراهنة في الشرق الأوسط).[2]
انتهى كلام فرومكين وهو تفسير دقيق، وتحليل عميق، للأزمة التي يعيشها العالم الإسلامي، فقد سقطت الخلافة العثمانية ـ مع ضعفها وهشاشتها قبيل سقوطها ـ فسقط معها الإسلام الدين والهوية، والإسلام الأمة والوطن، والإسلام النظام والدولة، والإسلام الشريعة والقانون، ليعيش المسلمون حالة من الاغتراب السياسي والفكري والثقافي والتشريعي غير مسبوقة في تاريخهم كله، لتعصف بهم الأحداث السياسية والمحدثات الأيديولوجية، فكان البديل العلمانية المادية الشيوعية والاشتراكية، والقومية والوطنية، والليبرالية والرأسمالية، التي اجتاحت العالم العربي والإسلامي، وقامت دويلات الطوائف الجمهورية والملكية، المدنية والعسكرية، فما ازدادت الأمة معها إلا ضعفا وتشرذما وتخلفا واغترابا، فهي بلا دولة، وبلا دين، وبلا مشروع سياسي وأيديولوجي، وبلا أهداف إستراتيجية!
لقد صدق فرومكين في تحليله ولم يصب في تنبؤاته، فلن يمر العالم الإسلامي بما مرت به أوربا ألف سنة ليحدد مستقبله، بل ستعود خلافة راشدة وأمة واحدة من جديد، كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بشر بفتح القسطنطينية فتحققت بشارته في أضعف مرحلة تاريخية مرت بها الأمة!
لقد ظهرت الحركات الإسلامية بعد سقوط الخلافة العثمانية، كردة فعل واستجابة طبيعية، وحاولت إحياء موضوع الخلافة إلا أنها أخفقت في ذلك، وكان الخلل يتمثل في:
1 ـ عدم بلورة مشروع الخلافة كنظام سياسي واضح المعالم يعبر عن الإسلام كدين وعقيدة ـ كالنظم الاشتراكية للشيوعية، والنظم الديمقراطية لليبرالية ـ والعجز عن بعثه من جديد على أصول الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة في عصر الخلفاء الراشدين، ومعالجة مشكلات الواقع من خلال فقه المقاربات لهذا الخطاب مرحليا، فكانت الحركات الإسلامية على حالين:
· إما حركات همشت هذا الموضوع ولم يعد من أولوياتها واهتماماتها أصلا كالحركات الصوفية والحركات السلفية المعاصرة.
· أو حركات أولتها أهمية غير أن تصوراتها عن الخلافة ظلت رهينة الخطاب المؤول وما قرره الفقه المؤول كما عبرت عنه كتب الأحكام السلطانية والسياسة الشرعية، وهو ما لم يجد قبولا لدى عامة المسلمين ونخبهم السياسية والثقافية التي تتطلع إلى واقع جديد لم تجده في خطاب هذه الحركات، فليس في خطابها تأكيد على حق الأمة في اختيار السلطة، ولا حقها في الحرية السياسية والتعددية، ولا حقها في العدل والمساواة، ولا حقها في مقاومة الاستبداد، ولا حقها في مقاومة الاستعمار- وإن حاولت مؤخرا استدراك ذلك - وظلت أشد الحركات الإسلامية عناية بموضوع الخلافة أبعد الحركات عن ممارسة أي عمل سياسي يؤدي إلى التمكين! بل ظلت حبيسة تصورات سطحية غير شرعية وغير عقلية وغير سياسية عن كيفية إعادة الخلافة!
فلما قامت أول تجربة في السودان بعد ستين سنة من العمل الإسلامي السياسي كانت أسوأ نموذج يمكن تقديمه باسم الإسلام، فهي تجربة بلا هوية دينية، ولا عقيدة سياسية، ولا حرية وتعددية، فكانت أشبه بأي نظام عربي آخر منها بالنظام السياسي الإسلامي!
وفي الوقت الذي نجحت فيه الأقلية الشيعية في إيران من بلورة مشروع سياسي وفق نظرية ولاية الفقيه، بعد تجاوز إشكالية انتظار المهدي ليقف الشعب الإيراني مع مشروعها السياسي، ظلت الأكثرية التي تمثل تسعين بالمئة من الأمة إلى اليوم بلا مشروع سياسي!
2 ـ عدم قيام تنظيمات سياسية سنية، تحمل مشروعا سياسيا يعبر عن الخطاب السياسي السني الراشدي، وتناضل من أجل تحقيقه، وهو نتيجة حتمية لعدم وجود المشروع السياسي السني أصلا، ففي الوقت الذي قامت تنظيمات شيعية تحمل المشروع السياسي لولاية الفقيه وهي نظرية حديثة لم يعرفها الشيعة إلا في هذا العصر، لم يقم في المقابل أي تنظيم سياسي يحمل المشروع السياسي السني الراشدي، مع أن الخلافة الإسلامية كنظام سياسي ظل يحكم واقع الأمة ثلاثة عشر قرنا! وحتى حزب التحرير الذي جعل قضيته المركزية قضية الخلافة، وتسمى باسم الحزب، ظل جماعة إسلامية دعوية وفكرية دون أي نضال وصراع سياسي من أجل تحقيق ما يصبو إليه!
3 ـ عجز الحركات الإسلامية في العالم العربي خاصة، عن التأثير في الواقع السياسي، وعجزها عن معالجة مشكلات الأمة من خلال منظورها الأيديولوجي السني، ابتداء من مشكلة القطرية وتحديد الموقف منها وكيفية التعامل معها، ومشكلة الاستبداد السياسي الذي جعل ثلاثمائة وخمسين مليون عربي مسلوبي الإرادة والتأثير في واقعهم وكيفية مواجهته، ومشكلة الاحتلال الأجنبي وسيطرته على المنطقة، ومشكلة انتهاك حقوق الإنسان، ومشكلة الفقر، وتخلف التنمية، إلى آخر المشكلات التي تعصف في العالم العربي خاصة، والإسلامي عامة!
إن ضرورة استدعاء الخطاب السياسي السني الراشدي اليوم ـ فضلا عن كونه ضرورة شرعية وسياسية ـ وأهمية بلورة مشروع سياسي يقوم على أصوله وقواعده، تكمن في عناصر القوة التي يضمنها مثل هذا الاستدعاء لهذا الخطاب والتي تتجلى فيما يلي:
أولا : ربط المشروع السياسي الإسلامي بالأيديولوجيا العقائدية التي هي الأساس لنجاح أي مشروع سياسي لكي تتجاوب معه الحماهير المؤمنة به، فإذا كان النظام السياسي الاشتراكي يعبر عن الفلسفة الشيوعية كأيديولوجيا وعقيدة سياسية، والنظام الديمقراطي يعبر عن الفلسفة الليبرالية التي عبرت عن المسيحية البرتستانتية كدين وعقيدة سياسية، والنظام السياسي الإيراني اليوم يقوم على أساس ولاية الفقيه الذي يستند على عقيدة انتظار المهدي والعقيدة الشيعية الإمامية، والصهيونية تستند على وعود التوراة المزعومة، فإن المشروع السياسي الإسلامي يحتاج إلى أيديولوجيا عقائدية يعبر عنها، ويقوم عليها، ويستند إليها في إثبات مشروعيته وضرورته وقدرته على تحقيق الهوية والمحافظة على خصوصيتها.
ثانيا: وضوح أصول الخلافة الإسلامية كنظام سياسي وقوة أساسها الديني الذي تقوم عليها، إذ تواترت نصوصها تواترا قطعيا، كما أجمعت الأمة على أصولها العامة، ونقل ذلك علماء السنة في كتبهم العقائدية والفقهية كما قال النووي (وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة).
وقال أيضا (واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا).
ونقل الإجماع عليه القرطبي وقال (هذه الآية ـ {إني جاعل في الأرض خليفة} ـ أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة، وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة .. فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين).
كما أجمعوا على أنها تنعقد بالشورى والاختيار ...الخ.
فإذا كانت ولاية الفقيه تجد اعتراضا شديدا من عامة المراجع الشيعية لكونها تعارض أصل الانتظار للمهدي الغائب، فإن أصول الخلافة العامة محل أجماع سلف الأمة، وأئمة علماء السنة، بل لا وجود ولا قيام لمذهب أهل السنة والجماعة إلا بالخلافة (الدولة الواحدة)، والجماعة (الأمة الواحدة)، بل إن شعار (السنة) قائم أصلا على عقيدة إثبات خلافة الخلفاء الراشدين، وأنها بالشورى والاختيار لا بالنص أو الاضطرار أو الإجبار!
ثالثا: أن الخلافة ليست نظرية سياسية أو عقيدة دينية فقط، بل هي الواقع السياسي التاريخي للأمة مدة 1300 سنة، ففي ظلها قامت الدولة الإسلامية، وبفتوحاتها التاريخية امتدت جغرافيا وديمغرافيا، وفي أحضانها قامت الحضارة والرقي والتطور الذي عاشه العالم الإسلامي على تنوعه القومي والديني والثقافي، ولم يمض على سقوطها وغيابها أكثر من مائة عام، بل مازال بين أظهرنا اليوم من أدركها وعاش تحت ظلها كنظام سياسي إسلامي قائم على وحدة الأمة، ووحدة الدار، ووحدة السلطة، ومعبر عن دينها وهويتها وخصوصيتها، وهو ما يجعل استدعاءها اليوم أسهل وأيسر، لا من حيث التنظير فقط بل التطبيق أيضا.
رابعا: أن الخلافة كنظام سياسي ومؤسسة حكم نجحت في عصور كثيرة من تطوير مؤسساتها وآلياتها مع تطور الحياة السياسية، فكانت أقدر على الاستجابة للظروف المحيطة بها من كل الأنظمة التي عرفها العالم، ولهذا عرفت الخلافة صلاحيات الخليفة والوزير، والخليفة والسلطان في العصر العباسي - بعد أن قويت شوكة الأمراء وضعفت شوكة الخلفاء - وهو نظام أشبه برئاسة الوزراء - كما عرفت صلاحيات الخليفة والصدر الأعظم، والدستور والبرلمان، في العصر العثماني، وهو ما يؤكد حيويتها وقدرتها على مسايرة تطور العصور كمؤسسة حكم وكنظام سياسي ما جعلها تواجه كل التحديات مدة 1300 عام، وهي أطول الأنظمة السياسية التي عرفها العالم عمرا، ومن ثم فالواجب أن تكون الخلافة كمشروع نظام سياسي مواكبا لتطور العصر وضروراته، فكل وحدة أو اتحاد ترتضيه شعوب الأمة ودولها كلها، أو أكثرها، أو مجموعة من الدول الرئيسة فيها ذات السيادة والاستقلال عن أي نفوذ أجنبي، وتجتمع في أي إطار وحدوي أو اتحادي، وتكون حكوماته منتخبة من شعوبها، ويختار مجلسا رئاسيا يمثل الأمة التي اختارته كمجلس خلافة للأمة، ومجلس شورى منتخب يمثل شعوبه وأهل الحل والعقد منهم، فهو خلافة شرعية.
خامسا: أن البديل عنها الذي أقامه الاستعمار الغربي قد أثبت فشله وضعفه، فلا هو حقق أمنها واستقرارها، ولا حقق تطورها ونموها وازدهارها، ولا حافظ على هويتها وخصوصيتها، ولا أقام دينها وشريعتها.
سادسا: أن عودة الخلافة من جديد هي بشارة نبوية تواترت تواترا معنويا في أحاديث كثيرة كما في حديث (ثم تعود خلافة على نهج النبوة) ولم تعرف الأمة في تاريخه كله غيبة الخلافة إلا في هذا العصر مما يبشر بعودتها، ومعلوم ما للبشارة العقائدية من قدرة على استثارة المشاعر الجماهيرية نحو تحقيق أهدافها.
سابعا: أن اتجاه دول العالم نحو الوحدة والاتحاد الإقليمي والقاري، كما في الاتحاد الأوربي، يفرض على العالم الإسلامي الاتجاه نحو الوحدة والاتحاد الطوعي الاختياري برضا الشعوب وحكوماتها، في عالم ليس للضعفاء فيه مكان، كما يؤكد هذا الاتجاه العالمي إمكانية الوحدة والاتحاد بين دول العالم الإسلامي، إذ ليس في الاتحادات الأخرى من الشروط الموضوعية المتوفرة لتحققها، كالدين الجامع، واللغة الجامعة، والتاريخ المشترك، والمصلحة المشتركة، كما في العالم العربي والإسلامي، حيث اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الإسلام في كل مكان، وحيث القبلة الواحدة نحو البيت الحرام، وحيث الحج إلى مكان واحد، وحيث الثقافة الروحية الواحدة!
إن كل هذه العناصر تجعل من العمل على بلورة هذا المشروع السياسي خيارا استراتيجيا، إلا أن نجاحه وتحققه على أرض الواقع مرهون بتحقق أهدافه المرحلية المفصلية التي تتمثل في:
1 ـ تعزيز الحريات العامة في كل بلد لتحرير إرادة شعوب الأمة من الاستبداد الذي صادر حريتها وإرادتها حتى لم يعد لشعوبها أي أثر في مجريات الأحداث التي تعصف بها، فمتى تحررت إرادتها، واختارت حكوماتها التي تعبر عن توجهاتها وتطلعاتها، فلن تختار الأمة إلا الإسلام.
2 ـ تعزيز الوحدة بين شعوبها لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والعسكري بين دولها.
3 ـ التحرر والاستقلال عن كل أشكال الاحتلال والنفوذ الأجنبي الذي يحول دون حريتها ووحدتها وعودة شريعتها وخلافتها.
ولن يتحقق ذلك كله ما لم يقم التنظيم السياسي الدولي الذي يعمل على بناء نفسه، وبناء مشروعه، فكريا وتنظيميا، وتعزيز قدراته، ليكون قادرا على التأثير في مجريات الواقع السياسي في كل بلد يقوم فيه، ويستخدم كل الوسائل السلمية والمشروعة المتاحة لتحقيق ذلك، وهو ما يحتاج إلى تظافر جهود كبيرة من قبل قوى سياسية واقتصادية واجتماعية مؤثرة مع العزيمة والصبر والتضحية!
ويجب أن يكون شعاره (نحو أمة واحدة وخلافة راشدة) وأن يكون تحت اسم (مؤتمر الأمة) ليستعيد مفهوم الأمة الواحدة من جديد!


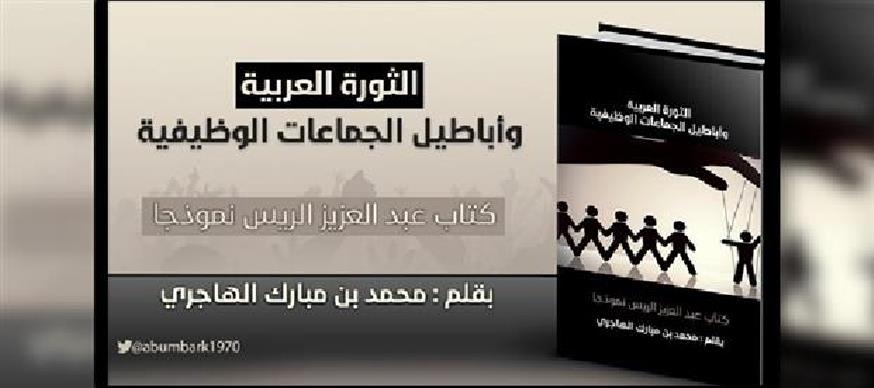
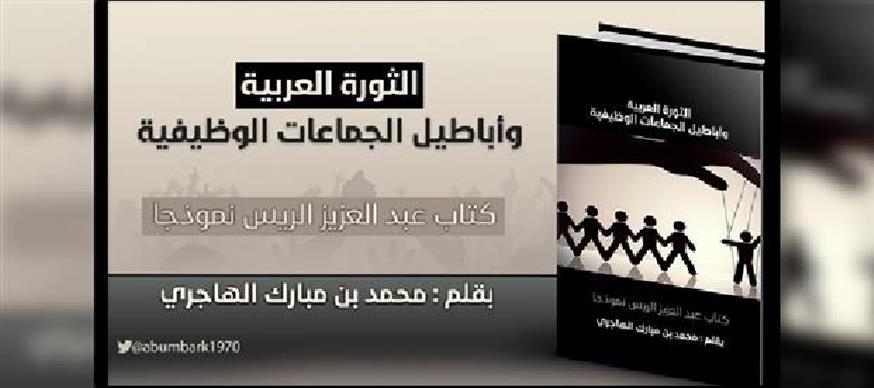
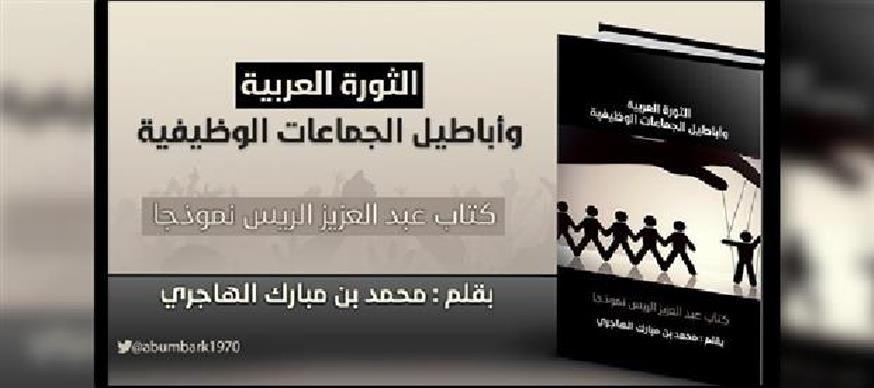
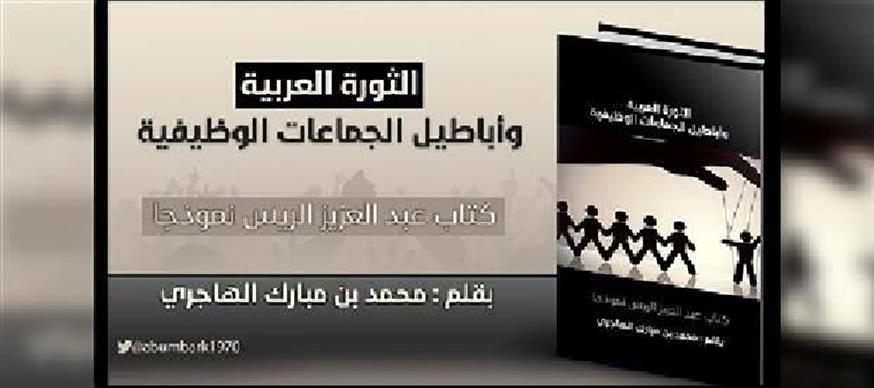
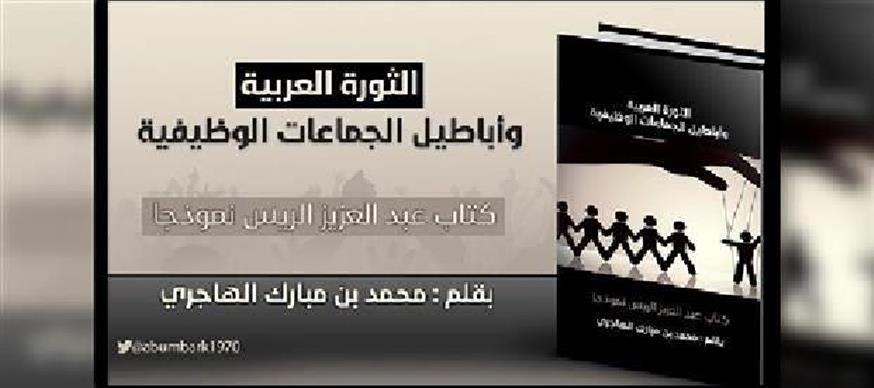
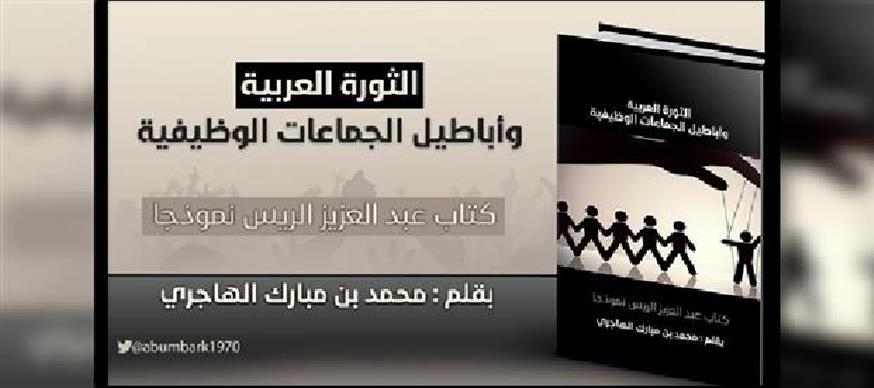



الأمة الأزمة والمخرج